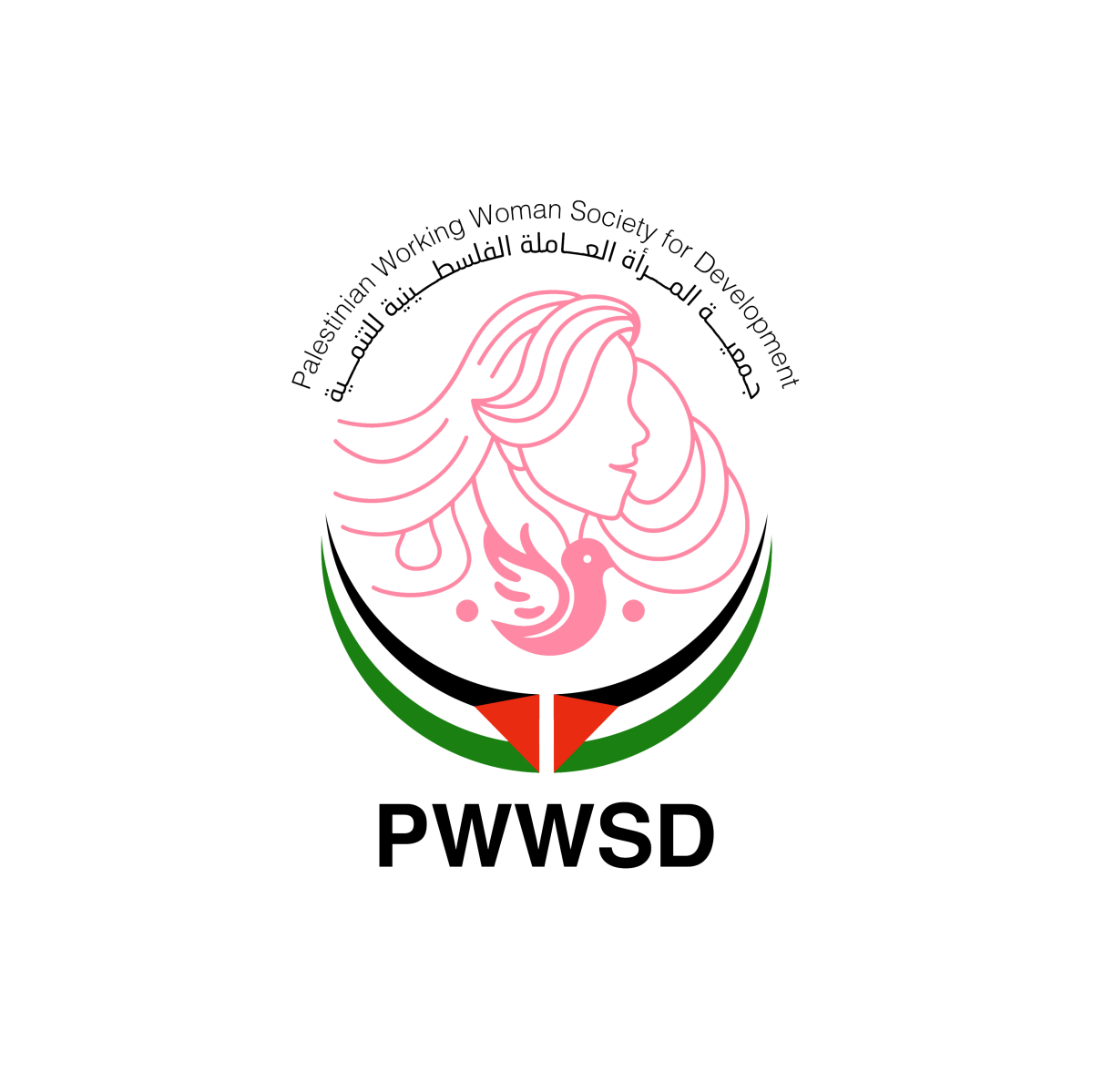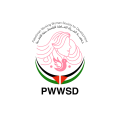ايمان المسارعي
قبل الحرب بأشهر، وتحديدًا بتاريخ 14 نوفمبر 2022، تم عقد قراني. عشت في بيتي بسعادة كبيرة؛ كنت أشعر بالاستقرار، بالأمن، وبالحب، رغم الظروف المحيطة. كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، والفرحة غطاء حريري يُدثر أرواحنا، والدفء الأسري يكسو أجسادنا.
بفضل الله، حملت وشكرت الله كثيرًا. غمرتني السعادة وكذلك زوجي، وكل من حضر حفل زفافنا. تم تحديد موعد ولادتي ليكون بتاريخ 17 أكتوبر 2023.
بدأت الحرب على غزة وأنا في شهري الأخير، أي مع اقتراب موعد ولادتي. تركت بيتي مجبرة بسبب القصف الذي كان حولنا، ونزحت إلى بيت أقارب زوجي، ولكن للأسف لم يكن الوضع هناك أكثر أمانًا.
اكتظ البيت بالنازحين الذين كانوا يسكنون شمال غزة؛ فتلك المناطق شهدت أعنف اشتباكات وتعرضت لقصف شديد نزح بسببه السكان هناك. الصواريخ كانت تطارد السكان، والخطر كان محيطًا بنا. لم يكن هناك أمان، وكل شيء حولنا كان يبعث على القلق والخوف.
استمر القصف ليلًا ونهارًا، وإطلاق الصواريخ كان يحدث بشكل مكثف. الانفجارات كانت تحدث حولنا، ولم نكن نملك سوى الدعاء.
كنت خائفة على نفسي وعلى الجنين الذي لم يرَ النور بعد. ما ذنبه أن يسمع دقات قلبي الخائفة، وخطواتي التي تركض صوب الحياة والأمان؟ كانت الأصوات مرتفعة وعنيفة لأول مرة نسمع مثلها.
تم تهديد البيت المجاور لنا بأنه سيتم قصفه، لذا غادرنا المكان خشية الإصابة. استمرت معاناتنا، ويومًا بعد يوم يزداد القصف بوحشية.
تركت بيتي يوم الأربعاء بتاريخ 11 أكتوبر 2023، وذهبت إلى بيت أهلي. اكتظت العمارة السكنية بالنازحين. الكل كان خائفًا، وحالة من الرعب والخوف سيطرت على الأطفال، الذين كانوا يصرخون كلما سمعوا دوي انفجار أو استهداف قريب منا.
في يوم الجمعة، ألقت الطائرات مناشير تطالبنا بضرورة إخلاء منطقة شمال غزة لأنها تعتبر منطقة قتال. نزحت مع أهلي والجيران وكل سكان الحي إلى منطقة الوسطى، وتحديدًا مخيم النصيرات.
كانت الطريق صعبة وطويلة؛ لم تكن هناك مواصلات. الجثث كانت ملقاة على الأرض، ويقشعر بدني كلما تذكرت الشبان الذين تفحموا في السيارة ولم يجدوا من ينقذهم، أو تلك العائلة التي تناثر أفرادها في شارع صلاح الدين: جثة صغير هنا، وهناك جثث البقية، ولم يجدوا من يحملهم ويواريهم الثرى؛ لأن كل من حاول المساعدة أو الإنقاذ يتم استهدافه وقصفه.
وصلت إلى مخيم النصيرات، وهناك جلست في منزل الأقارب.
اشتدت آلام المخاض. لم أستطع التحمل، وكل المشاعر السيئة انتابتني بسبب الوضع الراهن، لأن الطائرات كانت تقصف كل متحرك، وحتى سيارات الإسعاف.
كان هذا أول مولود لي، وكان الخوف شديدًا والقلق أكبر. أول مولود أضعه، والقصف يدك المكان بشكلٍ عشوائي. التوقيت كان سيئًا والوضع غير آمن وخطير.
اتصلنا بالإسعاف، لكنه لم يستطع الوصول إلا في تمام الساعة الرابعة فجرًا. تم نقلي إلى المستشفى، وهناك وضعت مولودي بسلامة، وأسميته خالد.
عدت إلى البيت الذي نزحت إليه، وكان القصف قد ازداد. تم استهداف الكثير من البيوت والمباني، وارتُكبت مجازر في مخيم النصيرات؛ حيث تم استهداف عمارة سكنية بأكملها وسقطت على من فيها.
لم نشعر بأن مخيم النصيرات آمن بسبب القصف المستمر ووقوع الكثير من المجازر. تداول الناس أن منطقة رفح هي منطقة خضراء، أي أنها آمنة ولا تشهد الكثير من عمليات القصف أو الاستهداف في البداية، أي في شهر يناير وفبراير.
مرة أخرى، تسقط المناشير على مخيم النصيرات وتبلغنا بضرورة إخلاء هذه المناطق إلى منطقة رفح.
غادرت مكان نزوحي وذهبت إلى رفح، وتحديدًا دوار العودة. كان الأمر مكلفًا كثيرًا نفسيًا وجسديًا وماديًا، خاصة وأنا من فترة عانيت آلام المخاض.
ساءت حالتي النفسية بسبب عدم الاستقرار وكثرة النزوح. دفعنا الكثير من المال من أجل الوصول إلى مدينة رفح.
وصلت إلى بيت أحد الأصدقاء، وهناك أيضًا بدأت معاناة جديدة بسبب اكتظاظ البيت بالنازحين والاختلاط الذي أثر على مولودي وصحته؛ فمناعته لا زالت ضعيفة، وكان عمره أقل من شهرين.
حولنا تم قصف بيوت، وتطايرت الشظايا وتحطمت النوافذ. لم أعد أشعر بالأمان في البيوت؛ أصبحت أقول: لا مكان آمن، لا بيت آمن. ضاع الأمان، ولم يبق إلا وجه الله.
بعد رحلة معاناة استغرقت أسابيع بين بيت يطالب صاحبه بالإيجار وأنا وزوجي لم نكن نملك المال لدفع ذلك، وبين مركز إيواء مكتظ بالنازحين والأمراض المنتشرة، أجبرتني الظروف السيئة على ترك مركز الإيواء والنزوح إلى مدرسة اعتقادًا مني أنها تابعة لوكالة الغوث فهي آمنة ولا يمكن استهدافها.
في المدرسة عانيت من الاختلاط والتكدس وانعدام النظافة. لم أستطع تحمل قلة الماء والطعام، حتى دورات المياه لم يكن بها ماء لغسل يدي بعد قضاء الحاجة.
الجو في المدرسة كان غير صحي وقد يسبب الأمراض المختلفة لطفلي، وهذا ما حدث للأسف. كنت أنام على الأرض في غرفة صفية مليئة بالنساء والأطفال، مما أدى إلى سرعة انتشار الأمراض المعدية.
عانى ابني من الرطوبة والمشاكل الجلدية. حملت طفلي وذهبت إلى المركز الصحي. تعاطف معنا أحد أفراد الأمن في المدرسة، وقام باستضافتنا في بيته مع طفلي وزوجي. عشنا لأول مرة بحياة كريمة لمدة شهرين، وكان طفلي ينعم بحمام دافئ وجو صحي.
فرحتنا لم تكتمل؛ فقد طلب الاحتلال منا ضرورة إخلاء مدينة رفح والنزوح إلى مواصي خانيونس بسبب الاجتياح البري الذي ستشهده مدينة رفح.
دارت بي الدنيا وضاقت بنا الحال، ومرة أخرى كان النزوح موعدًا جديدًا مع المعاناة والألم. لقد ضاعت مني لحظات السعادة؛ لم أشعر بها قط. لم أشعر بالفرحة عند وضعي لمولودي، ولا بزواجي، ولا حتى بحياة زوجية هانئة.
منذ البداية كانت حياتي نزوحًا، وألمًا، وتشريدًا، ولم أشعر بلحظة استقرار. تغيرت حالتي النفسية كثيرًا؛ فقد خسرت الكثير من الوزن، وزادت التجاعيد حول عيني، وأصبحت أكبر سنًا مما أبدو عليه.
بالإضافة إلى ذلك، لم أحصل على طعام صحي يناسبني كأم مرضعة. عانى ابني أيضًا من سوء التغذية؛ فلا طعام مخصص لعمره مثل السيريلاك أو الفواكه والخضروات، مما تسبب له بنقص في الفيتامينات.
لم أستطع حتى شراء ملابس خاصة له بسبب الإغلاق والحصار الخانق المفروض منذ بداية الحرب. عانى أيضًا من الأمراض الجلدية بسبب تكدس النازحين والاختلاط، كما عانيت انعدام الخصوصية.
وصلنا إلى مواصي خانيونس، وبدأت هناك مرحلة جديدة من المعاناة. الخيمة كانت رمزًا للألم الذي يخنق الروح. قمنا بإنشاء خيمة بطريقتنا الخاصة باستخدام بعض الأعمدة وقطع القماش.
في الخيمة، لم يجد طفلي المكان الصحي الذي يناسب نموه. كان الرمل والحصى الصغيرة عقبات أمام ممارسة طفولته البسيطة، بالإضافة إلى الحشرات التي لم نرها من قبل، والتي كانت تهدد حياته.
الخيمة كانت معاناة حقيقية. سقفها المصنوع من القماش لا يحمينا من أشعة الشمس اللاهبة. الجو بداخلها كان حارًا وخانقًا، ويكتم الأنفاس، ويُسبب الطفح الجلدي والحبوب في أجسادنا.
بتاريخ 13 يوليو 2024، وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا، كان الجو هادئًا ومستقرًا إلى حد ما. الجميع كان منشغلًا في أعماله اليومية؛ البعض ذهب للتسوق، وآخرون في أعمالهم، بينما النساء كنّ يطهون أو يعدن العجين، وكان الأطفال يلعبون ويلهون.
أما أنا، فقد كنت داخل الخيمة أرتبها، ووضعت ابني خالد أمام الخيمة ليشاهد الأطفال ويلهو معهم. فجأة، ومن دون سابق إنذار، حدثت ثلاث انفجارات متتالية بالقرب من مكان نزوحنا.
ثلاثة صواريخ هزت المكان، وقلبت الموازين رأسًا على عقب. سقطت الخيمة عليّ، وشعرت بأن قلبي قد سقط مني. تجمد الدم في عروقي، ووقعت شبه مغمى عليّ. أين أحتمي؟ وكيف؟ بماذا؟
الخيمة لم تكن تحمينا من الشظايا أو حتى من الغبار الذي ملأ المكان. اختبأت بين الفراش والملابس، ونسيت طفلي ومكان وجوده. بقيت مختبئة بين الأغطية، وكادت أنفاسي أن تنقطع.
الصواريخ استمرت في النزول بشكل متتالٍ، وكنت أسمع صراخ الناس وآهات الجرحى. الفوضى والهلع أصابا المكان، وأصوات الانفجارات لم تهدأ.
لحسن الحظ، جاءت جارتي وأخرجت ابني خالد من تحت الرمل والأغطية، وساعدتني على الوقوف والخروج من بين بقايا الخيمة التي تهدمت فوقنا. كان ابني مدفونًا تحت الرمل، ولكننا نجونا بمعجزة.
حملت ابني، وأمسكت بيد جارتي، وركضنا في الشارع بعيدًا عن مكان القصف، باحثين عن مكان آمن. المكان كان غارقًا بالفوضى والأشلاء المتناثرة، والخيام التي تهدمت على من فيها.
الغبار والدخان ملآ المكان، مما أثر على قدرتي على التنفس. ابتعدنا كثيرًا عن مكان الخيام المستهدفة، وجاءت سيارات الإسعاف لنقل الشهداء والجرحى.
بعد خمس ساعات، عدنا إلى مكان نزوحنا بعد أن هدأ الوضع. كان المكان مليئًا بالدمار، والناس الثكلى، وأصوات عويل الأمهات وبكاء الناجين.
قمنا بتنظيف المكان، وحاولنا رفع أعمدة الخيمة التي تهدمت، وأعدنا تخييط القماش الممزق. استغرق الأمر جهدًا كبيرًا لإعادة نصب الخيمة، والبحث عن قطع قماش إضافية لتغطيتها.
رغم كل الألم والحزن، عادت الحياة من جديد، ولكنها حياة مشوهة مليئة بالمآسي والذكريات المؤلمة. الجيران الذين ذهبوا ضحية هذه المجزرة كانوا عنوانًا للحزن. أمهات فقدن أبناءهن أو أزواجهن.
حتى الآن، لا يمكنني تصديق ما حدث. أنني لا زلت على قيد الحياة، وأن ابني خالد نجا. أحمد الله على كل حال، وأتمنى أن تنتهي الحرب لنعود إلى بيوتنا في شمال غزة، وننعم بحياة مليئة بالأمان والسلام.